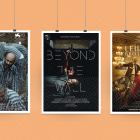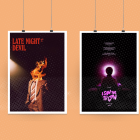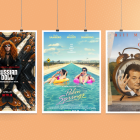فن
علي وصفية: الوجه الآخر لقصص الحب الخالدة
حين ينتقل الحب من صفحات الخيال إلى اختبارات الواقع، بعض الحكايات حين تكتمل تخسر سحرها... فهل كان الحب أصدق حين بقي حلمًا؟
 الشيخ علي يوسف وصفية السادات
الشيخ علي يوسف وصفية السادات
«سَأُضمِرُ وَجدي في فُؤادي * وَأَكتُمُ وَأَسهَرُ لَيلي والعَواذِلُ نُوَّمُ
وَأَطمَعُ مِن دَهري بِما لا أَنالُه * وَأَلزَمُ مِنهُ ذُلَّ مَن لَيسَ يَرحُمُ
وَأَرجو التَداني مِنكِ يا اِبنَةَ مالِكٍ * وَدونَ التَداني نارُ حَربٍ تَضَرَّمُ»
— عنترة بن شداد
في كتابي الأول «تذكرة سينما: نظرة كاشفة للواقع والحياة»، ختمتُ الفصول الإحدى عشرة بفصلٍ أخير لم يكن ضمن الخطة الأصلية، بعنوان: «محاولة أخيرة لفهم الحب». لم يكن هذا الفصل وليد تصور سابق، بل اقتراحًا من الصديق الكاتب محمد جمال، الذي اقترح أن أختم الكتاب بلمسة شخصية، فكان هذا الفصل بمثابة نافذة تأملية داخلية.
كتبتُ فيه عن تجربتي الخاصة مع الحب، مستلهمًا فضاءه من فيلم «الحب في الزنزانة»، ذلك الفيلم الذي شكّل خلفية شعورية مناسبة للغوص في حكايتي العجيبة مع الحب. ففي سنوات الثانوية، كنت قد أُعجبتُ بصديقةٍ لي، إعجابًا صامتًا لم أجرؤ على التصريح به، واستمر هذا الإعجاب ساكنًا داخلي سنوات طويلة. ومع اقتراب نهاية المرحلة الثانوية، بدأ أصدقائي يلحّون عليّ باتخاذ خطوة للتعبير عن هذا الشعور، لكنّي لم أفعل. لم تنشأ بيننا علاقة قط، وتزوجت هي، بينما بقيت أنا سجين أحلام يقظتي.
والمفارقة أن مشاعري تجاهها لم تَخبُ بعد زواجها، بل ازدادت اشتعالًا، رغم استحالة الموقف. ولم أكن أفهم السبب في حينه، إلى أن بدأت كتابة ذلك الفصل. وهناك فقط، وجدتُ الجواب:
«أنا أحب الصورة التي رسمتها في خيالي عنها، تلك الصورة الملائكية الخالية من العيوب.»
كان حُبي إذن حُبًا لصورة ذهنية مثالية، متجاوزة حدود الواقع، متعالية على النقائص. لم أحبها كما هي، بل كما تصورتها. ولهذا، كان من الصعب تجاوز تلك التجربة، لأنها لم تُختبر، ولم تُستهلك، ولم تُجرَّب. بقيت نقيّة، وبهذا اكتسبت طابعًا أسطوريًا.
الحب العذري
وهنا، يبرز جوهر ما أود الحديث عنه: الحب العذري. هذا النمط من الحب الذي لا يقوم على الواقع بل على الحلم. هو الحب الذي لا يُتوّج بتحقُّق، بل يتغذّى على البُعد، والشوق، والمُحال. كل حب عذري يحمل في طياته قداسةً غريبة، لأنه لم يدخل معترك الحياة اليومية؛ لم يُبتلَ بالمشاكل، ولا بالأعباء، ولا بالروتين.
تُحدثنا قصص الحب الخالدة — كقصة قيس وليلى، وروميو وجولييت، وعنترة وعبلة — عن نمط من العشق الجامح الذي يتجاوز حدود المنطق والمعقول. تلك الحكايات، رغم مآسيها، صارت عزاءً لكل عاشق لم يُكتب له الوصال بمعشوقه، ومأوى وجدانيًا لكل قلب ذاق مرارة الفقد. غير أن سؤالًا لا يغيب عن أذهان الكثيرين: ماذا لو كُتب لهذه القصص أن تكتمل؟ كيف كانت ستبدو حياة أولئك العشاق؟
(وهذه الأسئلة كانت تشغلني شخصيًا بسبب ما وضحته سابقًا)
ولحسن الحظ، ثمة قصة حب من ذلك النوع الجنوني نفسه، تحدى فيها الحبيبان الزمن والقيود، وتمكنا في نهاية المطاف من أن يكونا معًا. لكن، ما الذي جرى بعد أن تحقق الحلم؟ كيف مضت حياتهما؟ وما مآل ذلك الحب؟
كل هذه الأسئلة وغيرها، ستجد لها إجابة حين نقرأ حكاية علي يوسف وصفية السادات.
علي يوسف وصفية السادات
لم تكن قصة الحب التي جمعت بين الشيخ علي يوسف، أحد أبرز أعلام الصحافة في مطلع القرن العشرين، وصفية السادات، ابنة أحد أعيان مصر، مجرد علاقة عاطفية عابرة، بل كانت مواجهة مفتوحة بين الحب والسلطة، بين العاطفة والتقاليد، بين الصعود الاجتماعي والحواجز الطبقية الصارمة.
نشأ علي يوسف في صعيد مصر، في بيئة متواضعة الحال، ثم ارتحل إلى القاهرة وهو بعدُ فتى يافع، باحثًا عن العلم والمعرفة في أروقة الأزهر الشريف. وهناك، تفتحت مداركه، وسرعان ما انجذب إلى العمل الصحفي، ليتحوّل خلال سنوات قليلة إلى واحد من كبار الكُتّاب والصحفيين في مصر.
أسّس جريدة «المؤيد»، التي صارت لسان حال الحركة الوطنية، ونافذة لأفكار الإصلاح والنهضة، وأصبح اسمه معروفًا لدى الخاصة والعامة، مُهابًا من السلطة، ومحبوبًا من القرّاء.
وفي ذروة مجده المهني، تعرّف إلى صفية السادات، فتاة من بيت عريق، فهي ابنة الشيخ عبد الخالق السادات، من كبار الأشراف ونقيب العائلة الحسينية في القاهرة، وصاحب الجاه والنسب والثراء. أحب علي يوسف صفية، وأراد أن يتزوجها، لكنه اصطدم منذ اللحظة الأولى بعقبة لم يكن سهلًا تجاوزها: الفارق الطبقي.
ففي نظر الشيخ عبد الخالق، كان علي يوسف صحفيًا، أي من طبقة دون النُبلاء، ومهنته – رغم مجدها في عيون الناس – لم تكن في عُرف النخبة الأرستقراطية سوى حرفة وضيعة لا تليق بمقام العائلة.
ومع ذلك، فإن سُمعة علي يوسف، ومكانته المتعاظمة، فرضت نفسها، فوافق الشيخ على الخطبة على مضض، لكن دون أن يُحدد موعدًا للزواج، تاركًا الأمور معلّقة لسنوات، في مماطلة صريحة لا تخلو من الازدراء.
مرّت أربع سنوات من الانتظار والتسويف، وعلي يوسف لا يفقد الأمل، ولا يُظهر التراجع. وحين شعر أن الحيل والمراوغات لن تنتهي، قرر أن يُقدم على خطوة غير مسبوقة.
في عام 1904، وبينما كانت صفية في زيارة لمنزل خالها السيد البكري – نقيب الأشراف – فاجأهم علي يوسف بالحضور، بصحبة المأذون، وأعلن عقد قرانه على صفية، دون علم والدها، مستندًا إلى موافقتها الشخصية، وحضور أوليائها من جهة الأم.
كان الأمر أشبه بزلزال اجتماعي. غضب الأب غضبًا عارمًا، ورأى في ما حدث إهانة مباشرة لكرامته ونفوذه. ولم يتردد، فرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الشرعية يطالب فيها بإبطال الزواج، محتجًا بانعدام التكافؤ، ومعتبرًا أن المهنة التي يمتهنها علي يوسف لا تليق بمقام العائلة.
أصدرت المحكمة في البداية حكمًا يقضي بضرورة تسليم صفية لوليّها الشرعي، لكن صفية رفضت العودة إلى بيت والدها، واختارت الإقامة لدى الشيخ الرافعي، القاضي الشرعي المعروف، ما عُدّ آنذاك تمردًا على سلطة الأب، وخطوة جريئة من فتاة في مطلع القرن العشرين.
استمرت القضية تتداول في المحاكم، بينما الصحف تمتلئ بالتقارير، والمجالس تتناقل الخبر كقصة حب بطولية تُهددها الأعراف، وتحاصرها التقاليد.
وأمام هذا التحدي الصريح، بدأ الشيخ عبد الخالق يشعر بأن موقفه آخذٌ في التآكل، فوافق في نهاية المطاف – بعد أن شعر بأن كرامته قد استُعيدت – على إعادة عقد الزواج بعقد جديد رسمي، ليطوي بذلك صفحة الصراع القضائي، ويُرضي المجتمع والدين معًا.
لكن نهاية القصة لم تكن سعيدة كما يأمل العشّاق.
فقد دخل الزوجان عش الزوجية وقد أرهقتهما المعركة. ووفق ما ورد في عدد من الروايات، فإن علي يوسف لم يجد في الحياة الزوجية مع صفية ما كان يحلم به؛ فقد شاعت بين المحيطين به أنها دائمة التذمر والشكوى، وأنه كان يهرب من ضجيج الخلاف إلى جريدته، حيث يجد المتنفس الحقيقي لشغفه.
وفي عام 1913، تُوفي علي يوسف، وقد أفنت الصحافة روحه، بينما تزوّجت صفية لاحقًا من زكي عكاشة، أحد الممثلين المعروفين في ذلك الوقت.
وهكذا، تنتهي قصة حبٍ بدأت بنار التحدي، واشتعلت بضوء الكفاح، لكنها لم تصمد طويلًا في وجه الواقع القاسي، الذي لا يعترف بالأحلام حين تدخل بيت الزوجية.
قصة علي يوسف وصفية تُجسّد بامتياز فكرة المقال: أن الحب الذي يتوهّج في الخيال قد يخبو حين يصطدم بالواقع. وأن العاطفة، مهما بلغت سطوتها، قد لا تصمد أمام تقاليد متجذرة، ولا أمام الحياة حين تُطالب برودَينها اليومي من الصبر والتفاهم.
ختامًا
ليس من الغريب أن يبدو الحب في القصص والروايات أكثر نقاءً وبهاءً. فالخيال لا يعترف بالروتين، ولا بالمشكلات المالية، ولا بالضغوط اليومية. الحب هناك دائمًا نقي، يتوهّج بالشوق، ويتلألأ بالتضحية.
أما في الواقع، فالحب لا يُولد كاملًا، بل يُبنى. لا يكفي فيه الإعجاب، بل يحتاج إلى صبر، وتفاهم، واستمرار. هو ليس قصيدة رومانسية، بل شراكة تحتمل ما لا تحتمله القصائد.
نعم، الحب في الخيال يبدو مثاليًا، لكنه في الواقع أصدق، لأنه يُختبر. ولأن الحقيقة لا تسمح بالهروب من العيوب، بل تدعونا إلى القبول، والتجاوز، والمضي قدمًا.
«يبلغ الحب نُضجه؛ لا لأنه خالٍ من العيوب، بل لأنه قادر على البقاء رغمها.»